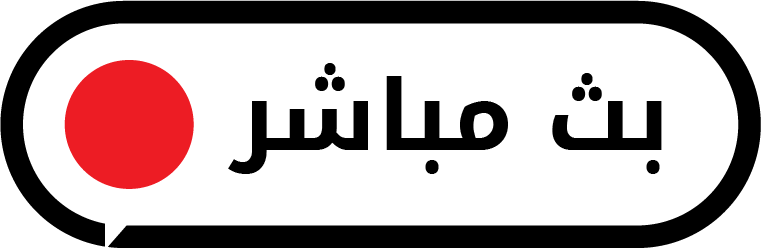أنت هنا
القائمة:
14 أيلول – تذكار "رفع الصليب الكريم المُحيي"
في هذا اليوم، الرابع عشر من شهر أيلول، تُقيم الكنيسة المُقدّسة بشقّيها الشرقيّ والغربيّ، تذكار "رفع الصليب الكريم المُحيي"، الذي حمله ربنا يسوع المسيح في طريقه إلى الجلجلة، ثم عُلِّقَ عليه مُسمَّراً بين لِصَّين و"محسوباً مع الأثمة" (مرقس 15: 28) "صائراً لعنةً لأجلنا" (غلاطية 3: 13)، ومُسمِّراً عليه صكّ خطايانا (كولوسي 2: 14)...
هذا التذكار هو عيد تكريميّ كبير للصليب، أداة خلاصنا نحن البشر، ورمز هويّتنا وعنوان فخرنا نحن المؤمنين... في الكنائس التي تتّبع الطقس البيزنطيّ، هذا العيد يُشكّل أحد الأعياد السيّديّة الكُبرى من الدرجة الأولى، مُبطِل لخدمة القيامة، وهو العيد السيّديّ الوحيد الذي ليس موضوعه حدث من أحداث حياة السيّد (كالميلاد، أو التجلّي، أو القيامة، أو الصعود...).
في الليترجيا الإلهيّة لهذا اليوم، نقرأ فصلاً من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس (1كور 1: 18-24)، وفيه يتكلّم عن الصليب بالنسبة للمنطق الإلهيّ المُغاير للمنطق البشريّ. كما نقرأ أيضاً فصلاً من الإنجيل بحسب يوحنا (يو 19: 6-35)، وفيه يروي لنا الكاتب "الحبيب" (الواقف على أقدام الصليب)، الحكم على يسوع بالموت صلباً، وصلبه بين "لِصَّين" وموته ثم طعنه في جنبه، وخروج دم وماء...
**************************************************
أولاً – الصليب في الروزنامة الطقسيّة:
تتميّز السنة الطقسيّة البيزنطيّة بعدّة تذكارات للصليب الكريم:
* الأول هو بالطبع يوم "الجمعة العظيم المُقدّس"، وهو الأساس لأنه يوم حدث الصلب ويوم الصليب بإمتياز، يوم "رفع إبن البشر ليجذب إليه الجميع"، ومنه تنبع بقيّة التذكارات. لكنّه مُخصّص لتذكار آلام ربنا الخلاصيّة وموته على الصليب، أكثر منه تكريماً للصليب بحدّ ذاته.
* الثاني هو الأحد الثالث من "زمن التريوذي"، وهو محطّة في منتصف الصوم تضع الصليب أمام أعيننا، وتُشدّدنا في جهادنا الروحيّ على طريق إحتفالنا بقيامة الربّ، مُذكّرةً إيّانا بأنه لا قيامة من دون صليب.
* الثالث هو في الأول من شهر آب، حيث كان يجري قديماً في القسطنطينيّة تطواف بالصليب الكريم، درءاً للأمراض التي كانت تتفشّى في فترة الصيف، وإستعداداً لعيد "رقاد السيّدة".
* الرابع هو في الرابع عشر من شهر أيلول (أي تذكار اليوم)، وأساس هذا التذكار هو العثور على الصليب الكريم من قِبَل الملكة هيلانة ورفعه مرّة أولى بتكريم كبير، وفي ما بعد تذكار رفعه مرّة ثانية من قبل الإمبراطور هرقل بعد إسترداده من الفرس... الجدير ذكره هو أن تذكار اليوم يقع على مسافة أربعين يوماً بعد عيد "تجلّي الربّ على الجبل"، على أساس أن حدث صلب الربّ يسوع وقع بعد حدث "تجلّيه على الجبل" بأربعين يوماً (بحسب القديس يوحنا الذهبي الفم)، وكأننا نحيا "زمن صوم أربعينيّ جديد"، "صوماً صيفيّاً" إن صحّ التعبير، إستعداداً للإحتفال بعيد الصليب... نذكر أخيراً أن تذكار اليوم يفتتح زمناً طقسيّاً قائماً بذاته، "زمن الصليب"، ويمتدّ تقليديّاً إلى عشيّة بدء "صوم الميلاد الأربعينيّ" (14 تشرين الثاني).
------------------------------------------------
ثانياً – الأصول التاريخيّة للعيد:
بعد "محنة" الجلجلة، غاب كلّ ذِكر لصليب الربّ يسوع وساد الصمت صفحات التاريخ، كما صفحات الكتب المُقدّسة... وصولاً إلى القرن الرابع، وبعد إنتصار الإمبراطور قسطنطين الأول (الكبير) على غريمه ماكسانس (بوضعه إشارة الصليب على الرايات)، وبعد إعتناقه الإيمان المسيحيّ فيما بعد، قرّرت الملكة هيلانة (والدة قسطنطين) الذهاب إلى الأراضي المُقدّسة عام 326م، وأمرت بالبدء بالحفر قرب معبد "فينوس" الوثنيّ (المُشاد على جبل الجلجلة)، حيث يُرجّح أن يكون صليب الربّ يسوع مدفوناً منذ ما بعد الصلب، في حفرة كبيرة مُجاورة لمكان الصلب... وبالفعل، أثمرت الحفريّات في العثور على ثلاثة صلبان. لكن أيُها هو "الصليب الحامل الحياة"؟ أخيراً، إستقرّ الرأي على إقتراح بطريرك أورشليم مكاريوس، القاضي بتقريب كلّ صليب على حدة من إمرأة كانت على شفير الموت. وبعد تجربة الصليبَين الأولَين دون جدوى، شُفيَت المرأة كليّاً من مُصابها بلمسها الصليب الثالث، أعجوبة أظهرت للجميع صليب السيّد له المجد. فهلّل الشعب مُسبِّحاً، وتمّ رفع الصليب الكريم على جبل الجلجلة. بعدها، أمرت الملكة هيلانة بتشييد كنيسة على إسم "القيامة" فوق مكان رفع الصليب، وكان حفل تدشينها في 13 أيلول 335، حيث حلّ تذكار حدث التدشين مكان عيد وثنيّ، وحيث بقي عود الصليب مرفوعاً حتى عام 614م... والجدير ذكره هو طريقة إيصال الخبر السارّ عن العثور على الصليب إلى الإمبراطور في القسطنطينيّة، ألا وهي إشعال نار على قمم الجبال (من قمّة إلى أخرى)، وصولاً إلى العاصمة. من هنا العادة الشعبيّة في هذا العيد، بإشعال النار على القمم وفي الساحات العامّة.
وصولاً إلى العام 614م، حين إحتلّ الفرس أورشليم (من ضمن ما إحتلّوا)، وقتلوا ودمّروا ونهبوا وسبَوا ما أمكنهم، آخذين آلاف المسيحيّين أسرى. وكان الصليب الكريم من ضمن ما أخذوا معهم إلى بلادهم، حيث بقي هناك 14 عاماً. وفي سنة 628، إنتصر الإمبراطور هرقل على كسرى ملك الفرس، وأعاد عود الصليب الكريم إلى أورشليم. وفي إحتفال كبير، حمل هرقل العود الكريم على كتفَيه، سائراً به في الطريق المؤدّي إلى الجلجلة، ولابساً أفخر الحلل "بما يليق بالمناسبة"، لكنه سرعان ما شعر بقوة خفيّة تمنعه من التقدّم. فبادر زكريّا بطريرك المدينة، مُذكّراً الإمبراطور بأن الملابس الفاخرة والجواهر لا تتناسب أبداً مع فقر الربّ يسوع وتواضعه الأقصى... فخلع هرقل ثيابه الفاخرة وحذاءه وجواهره، وإستطاع حينها إكمال طريقه إلى داخل "كنيسة القيامة" (المُرمّمة) حيث رفع عود الصليب الكريم، بينما الشعب كان يسجد ويُرنّم "لصليبكَ يا سيّدنا نسجد، ولقيامتكَ المُقدّسة نُمجّد".
------------------------------------------------
ثالثاً – الصليب... وأبرز رموزه في "العهد القديم":
لقد رأى الآباء القدّيسون في الكثير ممّا ورد في "العهد القديم"، صوَراً رمزيّةً "إستباقيّة" للكثير ممّا ورد في "الحدث المسيحانيّ". وكانت للصليب الكريم "أداة خلاصنا" حصّة وافرة من تلك الرموز، نذكر أبرزها في ما يلي، وقد أدرجها المؤلّفون والمُنشِدون الكنسيّون في الصلوات والخِدَم الليترجيّة المُختلِفة:
* "شجرة الحياة" التي كانت تتوسّط الفردوس (تك 2: 9)، تُقابلها "شجرة معرفة الخير والشرّ" (تك 2: 9) التي كانت سبباً لهلاك الجبلة البشريّة (تك 3: 1-24). والصليب أضحى "الشجرة الحاملة للحياة الحقيقيّة".
* حطب المُحرقة في ذبيحة إبراهيم أبي الآباء، يرمز إلى الصليب. فيما يرمز إسحق إبنه إلى المسيح نفسه (إبن الله)، وإبراهيم إلى الآب السماويّ (تكوين 22: 1-14).
* بركة يعقوب (إسرائيل) لحفيدَيه إفرائيم ومنسّى (إبنَي يوسف)، حيث عكفَ يدَيه على شكل صليب (تكوين 48: 13-16).
* أمسك موسى بعصاه بأمر من الله، ومدّ يدَيه على البحر فشقّهُ، ليمرّ العبرانيّون عبره هرَباً من المصريّين، كأنهم على اليبس. ثم عاد موسى، فمدّ يدَيه ثانيةً على البحر، فرجع البحر إلى موضعه، مُغرِقاً معه فرعون وجيشه (خروج 14: 15-31).
* صلاة موسى باسطاً ذراعَيه، حين كان الشعب في برّيّة سيناء، وتعرّض للخطر من عماليق. وفيما هو في هذه الوضعيّة، كان الشعب ينتصر. أما حين كان يتعب ويُرخي ذراعَيه، كان الشعب يتقهقر. فطلب إلى "هارون" وإلى "حور" أن يَسندا ذراعَيه مبسوطتَين، إلى أن غُلِب عماليق (خروج 17: 1-16).
* تحلية مياه مرّان (أو مارّة)، بواسطة شجرة طرحها موسى في الماء بأمر من الربّ (خروج 15: 22-27).
* "الحيّة النحاسيّة" الشهيرة، وروايتها تقول بأن الشعب العبرانيّ، الذي خرج من عبوديّة مصر على يد موسى، تاه في برّيّة سيناء وطفق يتذمّر على الربّ إلهه. فبدأت الحيّات تلدغه، ومات من الشعب عدد وافر... فطلب الشعب إلى موسى أن يُصلّي إلى الربّ الإله ليُزيح عنه هذا "العقاب". وبعد أن صلّى موسى، أوصاه الربّ بأن يصنع "حيّة نحاسيّة" ويرفعها على راية، لكي يشفى كلّ من ينظر إليها بعد أن تكون لدغته حيّة (عدد 21: 4-9). وهذا التشبيه أعطاه الربّ يسوع بنفسه فيما بعد، حين تكلّم عن حتميّة "رفعه".
* وقوف الشعب على شكل صليب حول "تابوت العهد"، ثلاثة أسباط في كل جهة من الجهات الأربع (عدد 2: 1-34)، حيث رأى بلعام هذه التشكيلة وبارك بعدها بني "إسرائيل" (عدد 24: 5-9).
* عصا "هارون" التي أورقت وأفرخت (عدد 17: 1-11).
* ضرب موسى صخرةً بعصاه ضربتَين، حين عطش الشعب في البرّيّة، فأنبعت ماءً (عدد 20: 1-29).
* عصا موسى والضربات للمصريّين، حيث مدّ موسى يده وضرب مياه النهر، فتحوّلت مياه المصريّين إلى دم، مُهلِكاً السمك وحارماً المصريّين من الماء (خروج 7: 14-24).
* بسط شمشون يدَيه مُبعِداً الأعمدة ومُدمِّراً أعداءه (قضاة 16: 23-31).
------------------------------------------------
رابعاً – الصليب وبُعده الخلاصيّ:
صحيح أن تذكار اليوم هو إحتفال وإستحضار لحدث تاريخيّ، ألا وهو رفع عود الصليب الكريم في مناسبتَين تاريخيّتَين، إلا أن رمزيّة الصليب هي ما يُعطي للحدث أهميّته... فبإيماننا المسيحيّ الذي تسلّمناه من الرسل، بإيمان ما بعد "القيامة" و"العنصرة"، نعترف بأن الصليب هو "العلامة" التي بها إنتصر المسيح، غالباً الموت بموته. بالصليب، قال الله كلمته النهائيّة، من خلال الفداء الذي حقّقه "كلمته" الأزليّ، فداء مُتوّج بالقيامة وبالعودة إلى المجد الأزليّ.
إن ثمن الخطيئة (رفض الله والكبرياء عليه) هو الموت (البُعد عن الله وعن الحياة في الله). لكن حبّ الله أكبر من خطيئة الإنسان، فوعد الله هذا الأخير بالخلاص، وقضى التدبير الخلاصيّ أن يموت شخص واحد فداءً عن البشريّة جمعاء (وليس فقط "عن الأمّة" كما قال رئيس الكهنة حينها). وبما أن الخاطىء لا يُمكنه أن يمحو خطيئة آخر، وبما أن المائت لا يُمكنه إعطاء الحياة لآخر، وجُب على "الفادي" أن تكون له الحياة بذاته ليهبها للمائتين، وهذه الميزة لا تنطبق إلا على من له الجوهر الإلهيّ... لذلك، لم يكن هذا "الفادي الإلهيّ" سوى إبن الله المنزّه عن الخطيئة وحده، والذي تجسّد في ملء الأزمنة لأجل إتمام هذا الخلاص (بدأ الإتّضاع من تلك اللحظة). لكنه لم يكن ليموت ميتة عاديّة، إنّما موت الصليب تحديداً، وهو كان قد أعلنها لتلاميذه مراراً عديدة.
ولكن لماذا موت الصليب؟؟؟
بما أن الصلب كان العقوبة القُصوى في تلك الأيام، وكانت بمثابة إذلال ما بعده إذلال للشخص المحكوم، فقد إرتضى الله بأن يُعلّمنا أن المجد الحقيقيّ لا بدّ من أن يمرّ بالإتّضاع الأقصى. ويظهر ذلك من خلال قول الربّ "من رفع نفسه وُضع، ومن وضع نفسه رُفع" (لو 14: 11). وهذا ما أدركه بولس الرسول جيداً بقوله عن المسيح "أخلى ذاته، آخذاً صورة عبد... وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب..." (فيلبي 2: 7-8). كما أن بولس أدرك أن المنطق الإلهيّ هو مُغاير للمنطق البشريّ بقوله "إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المُخلّصين، فهي قوّة الله" (1 كور1: 18)... علاوةً على ذلك، فإن وضعيّة الصلب تكون مكشوفة ومنظورة من قبل الجميع، على مثال "الحيّة النحاسيّة" المرفوعة على الراية قديماً، وهذا ما قصده الربّ قائلاً "متى رفعتُم إبن الإنسان، عرفتم أنّي أنا هو" (يو 8: 28). فإن نظرنا إليه بإنسحاق القلب وتأملنا إلى أيّ مدى وصل به الحبّ للبشريّة، حيث صار عاراً لأجلنا، شُفينا من لدغة خطيئتنا ونلنا به الخلاص. فالصليب هو "العلامة" التي بها ينتصر كلّ منّا على سلطان الخطيئة، التي جرّت وتجرّ الموت علينا. زد على ذلك، أنّ للصليب بُعدَين، عاموديّ يربط الإنسان بالله والأرض بالسماء، وأفقيّ يربط البشريّة جمعاء شعباً مُخلّصاً.
إذاً بالصليب، فُتحت لنا أبواب الفردوس من جديد وإلى الأبد... بالصليب، أُطلِق آدم وأُعتِقت حواء... بالصليب، ذهلت الملائكة وخابت الأبالسة... بالصليب، أُبيد الموت ونحن أحيينا... بالصليب، هبط المسيح إلى الجحيم مُخلِّصاً آدم وذريّته... بالصليب، رأينا أن منطق الله هو مُغاير كليّاً لمنطق هذا العالم... بالصليب، تصالحنا مع الله وعرفنا أن لا حدود لمحبّته... بالصليب، صار إبن الله عاراً لأجلنا، لكي نُشفى من لدغة خطيئتنا ونعود إلى كرامة الأبناء.
من هنا، نُدرك بالطبع أن لا قيمة للصليب كقطعتَي خشب متعاكستَين، بل إنه يأخذ كلّ قيمته من شخص المسيح المصلوب. وباتت كلمة "المصلوب" بمثابة هويّة خاصّة بالربّ يسوع "أنتما تطلبان يسوع المصلوب" (متى 28: 5). لهذا السبب، لا يُصَوّر الصليب عادةً بدون المصلوب في الإيقونات البيزنطيّة (إلا في البعض القليل، كإيقونة اليوم مثلاً)، بالمنطق نفسه الذي بموجبه، لا تُصَوّر والدة الإله عادةً بدون إبنها (إلا نادراً جداً).
------------------------------------------------
خامساً – كلمة ختاميّة:
مع المسيح القائم من الموت، لم يعُد الصليب نهاية كلّ شيء، كما ظنّ وأراد صالبوه، بل أصبح خشبة العبور إلى القيامة والحياة الحقّة. وعلى هذا الإيمان، نحن الذين "إعتمدنا في المسيح، فلبسنا المسيح" ومُتنا عن العالم، أصبح الصليب مدعاة فخر وإعتزاز لنا، على مثال بولس الرسول الذي أعلن "حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح..." (غلاطية 6: 14). وفخرنا بالصليب، النابع من إيماننا ب"المصلوب – القائم"، نترجمه في حياتنا الشخصيّة بقبولنا لصُلباننا (وما أكثرها)، واضعين رجاءنا ب"الغالب الموت"... كما نُعبّر عن فخرنا هذا، بإشارة الصليب التي ترافقنا في كلّ أوقاتنا وأعمالنا على الصعيد الشخصيّ وفي جماعة المؤمنين. أما على الصعيد الليترجيّ، فنرسم إشارة الصليب عشرات المرّات في القداس الإلهيّ والخِدَم الليترجيّة المُختلِفة، مُعبّرين بذلك عن إيماننا.
الصليب هو رمز إنتمائنا إلى "شعب الله الجديد" المُشترى بدم الحمل، وإشارة الصليب هي خُلاصة بسيطة لإيماننا ب"الحدث المسيحانيّ" كاملاً، وهي إلتزام جدّيّ بهذا الإيمان. لذا، نحن مدعوّون اليوم بمناسبة تذكار "رفع الصليب الكريم المُحيي"، إلى تجديد إيماننا الغالي جداً، وإلى تصحيح حياتنا بما يتناسب مع كوننا أبناء الملكوت، واضعين نُصب أعيننا صليب الربّ، فيكون مُعيناً ومُشدّداً لنا في جِدّة الحياة.
بقلم الاخ توفيق ناصر (خريستوفيلوس)